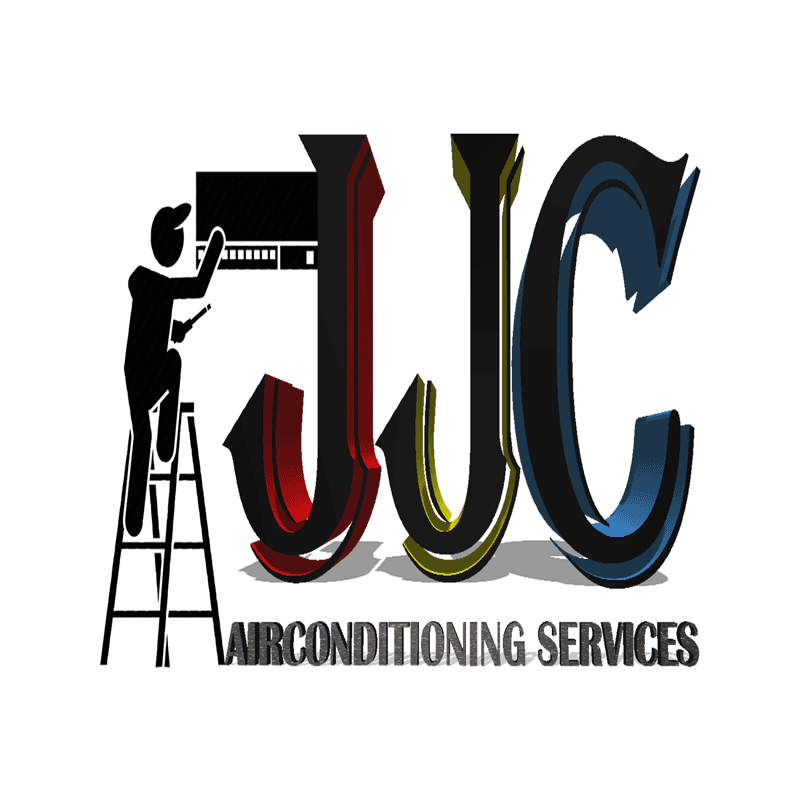ونحن نعيش وسط تفاقم الأزمات في الوطن، واشتداد وطأة وقسوة المحن، واللّجوء إلى لغة التفرقة والفتن، يتحرّك قلمي محاولاً التعبير عن ألمي، و يدمع فؤادي على ما آلت إليه بلادي، من تشتّتٍ وضياع، ومن تردٍّ للأوضاع، وسيطرة الشّلل على كل قطاع، وما يحدث أخيرًا من قطعٍ وإنقطاع، فتنقطع الكهرباء وتنقطع المياه، وينقطع في زمن الكورونا الدّواء، وتتقطع السّلع الغذائية، وتنقطع المواد الأساسيّة، وتقطع الدّروب والطّرقات، وتقطع الإتّصالات، ويقطع الوصال بين المسؤولين، وتنقطع حبال الودّ بينهم وبين شعبهم. ولكن البصيص يبقى، وخيط الأمل لا ولن ينقطع، وحبل الرجاء لا ولن ينقطع، طالما أن “الدنيا لن تخلو من الأوادم” بفضل مايقوم به بعض أهل الخير، لعلّ ذلك سيبدّد العتمة الدّامسة، ويوقظ الضّمائر النّاعسة، ويستجيب للنّداءات الهامسة . وقد سمعت خلال الأزمات الأخيرة عن رجل خير يعطي وإن لم يسأله أحد العطاء، يعطي ولا يمنّن، يقدّر ظروف النّاس، ويعاملهم بمحبّة واحترام وإحساس. وننطلق ببادرة توزيع الكهرباء بلا أرباح، من خلال تخفيض الفواتير بسعر الكلفة، وتقديم التّسهيلات وحتى إعفاء بعض المحتاجين، وكدنا نغار من المنطقة الخاضعة في الإنارة لشركة كهرباء جبيل، التي تغيب عنها أيضا لهجة الانقطاع التي تغزو البلد كما أسلفنا، ويعود الفضل في ذلك إلى صاحب” امتياز كهرباء جبيل وبيبلوس للتّعهدات الكهربائيّة” رجل الخير لا بل رجل الأعمال أو رجل الأقوال المقترنة بالأفعال الأستاذ إيلي جوزيف ملكان باسيل، فبينما يقوم البعض في هذه الظّروف برفع الأسعار وفرض الزّيارة ومن دون شفقة ولا هوادة، صنع الاستاذ إيلي بادرته، مراعيًا الوضع المأزوم والفقر المحتوم والجوّ المشؤوم.
فإنّي وان كنت أبتعد عن الكلام، إلا على الذين أعرفهم حقّ المعرفة، ولم أرد يومًا أن أكون المتنبّي في ديوان سيف الدّولة، أو من بائعي الكلمة في أسواق نخاسة المصالح، ولكن عاطفةً في قلبي نشأت نحو هذا الرّجل من دون سابق معرفة، لتعبر بصدقها المسافات والأبعاد، عبر الولوج إلى وسائل التّواصل، أو الإصغاء إلى أحاديث أرباب القلم، ومجالسة أهل القيم حول تقييمهم لتلك الأعمال، وفي طليعتهم الصّديق الأستاذ جورج كريم، ووجدتني أعتمد المبدأ القائل”من أعمالهم تعرفونهم” ،فمن منّا يقارب حديقة مسيرته الإنسانيّة، من دون أن يتنشّق أريج عطائه وبكل فرح وسرور، وهكذا نشهد للحقّ في أيّام تقوم الشهادات على الضّلال والتّضليل، وتتيه في غابات نكران الجميل.
إنّه ذلك الوجه الذي نشأ يتيما بعد موت والده بعمر السّابعة والثّلاثين ،وقد كان ذلك الوالد مقداماً بين بني قومه، ووجيهًا في منطقته، ولطيفًا في معاملته، وبهيًّا في طلّته، كما وصفه بعض مجايليه، كما كان رائدا في مواسم العزّ أي موسم الحرير والقز، وهو مالك مصنع الحرير الذي ما زالت آثاره حتى اليوم. ثم إنطلق الأستاذ إيلي من رحاب الفيدار إلى العالم الأوسع، وانطلق من بيتٍ كريمٍ إلى مسافة الوطن، وكما هي معقودة قناطر” جسر زبيدي” عقد عزيمته على السّفر، وعلى عمل الخير، وهو في عمر الشّباب، وكما تجري مياه نهر إبراهيم من تحت تلك القناطر، قاصدةً أراضي مدينة جبيل، جرى قاصدًا ديار العالم الجديد، حالمًا ببناء مملكته المنتظرة، والقائمة على الكفاح والعصاميّة، وحاملا ذخائر قدّيسي لبنان وعطر الأجداد.
و الفيدار تعني” الفَدار” أي استعمال ما يدّخر وقت الإحتياج، ولكن الاستاذ إيلي تجاوز ذلك، فجعل مدّخراته وشركته في خدمة النّاس وتأمين إحتياجاتهم، وتجلّى ذلك فيما ذكرناه آنفًا، فهو يعمل على الإفادة من دون أن يسعى إلى الاستفادة، ويهدف إلى العطاء اللّامتناهي، فكما أشبع السيد المسيح الخمسة آلاف شخص بمباركة السّمكتين والخمسة أرغفة، راح فاعل الخير إيلي باسيل يوزّع الحصص الغذائيّة على خمسة آلاف عائلة جبيليّة وفي خلال خمسة أسابيع ،نعم لقد عمل لإخوته الصغار ما عمله الرب الإله، وإن كان يفضّل الصّمت لكن صدى خيراته يتردّد في أرجاء بلاد الحرف من “مرمى الثّلج إلى فقش الموج” و لم ينحصر ذلك الصّدى وإن تهادى بين نهر إبراهيم ونهر المدفون ليسقي بعبقه أرجاء الوطن. ناهيك عما سرّبته إليّ” العصفورة” من أنه لكم سدّد و يسدّد من الفواتير الإستشفائيّة لمحتاجيها من أصحاب الأمراض الخبيثة والمزمنة، ومن دون أن يدع يساره تعلم ما صنعت يمينه، وهكذا يتراءى لي ذلك الإنسان الذي يعيش الإنسانيّة من دون أن يعظها، ويقوم بالخدمات من دون أن يمنّنها ويلبّي طلبات الناس ويقابل بطلباتهم أي صلواتهم، ولا غرو في ذلك فهو سليل عائلةٍ عريقةٍ ومحبّةٍ وفاعلةٍ وناشطةٍ وخدومةٍ وحاضرةٍ على السّاحل الجبيليّ التاريخيّ، وقد أعطت للمجتمع خيرة أبنائها، منهم من تشرّفت بمعرفتهم كالرّيّس جوزيف رحمه الله وقد اخترته يومًا وجعلته موضوع أولى كلماتي في المميّزين من أبناء بلاد الحرف، وكالرّيّس شارل رئيس بلديّة حالات الراحل ذلك الرجل القيدوم والمعطاء، كما تشرّفت بمعرفة وصداقة المديرة صولونج و الرّيّس ناجي والدّكتور نعيم والسّيدة أمال فرحات باسيل….أمدّهم الله بالصحة والنشاط ، وسمعت كثيرًا عن رجل العطاء والإقتصاد والسّياسة رئيس جمعية المصارف السابق الدّكتور فرنسوا باسيل وعلاقته بالعمران، من عمران البشر في الجامعات والمدارس، إلى بنيان الحجر في الأسواق والكنائس… كما إنّي قد استقيت من أحد المصادر، أن الفدار تعني أيضا” البيت أو الدّار البهيّج” فإذا به يستحيل حزينًا يوم رحلت جميلة الدّار، جميلة الفدار، جميلة الخُلق والخَلق، وصاحبة الأعمال الإنسانيّة ومديرة المشاريع الخيريّة،وكانت بالنسبة لرب البيت بمثابة” شجرة العائلة المثمرة والشّجرة المثمرة تحمل ثمارًا جيدة ، وتجلّت تلك الثمار في “حلوينة النبي” أي في يوسف وياسمين،” حيث تعلق الآمال عليهما، من آجل الحفاظ على الإرث الثمين ومواصلة المسيرة الغالية،وستبقى الأم الحنون تسهر من سمائها على أرضها،،وستبقى جميلة تحلق من عليائها وتضفي على تلك العائلة سمو الأخلاق وجمال الروح.
أمّا الصّدفة وإن كانت حزينة، فلقد حصلت يوم وداع الزّوجة الجميلة وبالتّالي قصدت كنيسة سيّدة الدّوير مع بعض مواطني الحصاراتيّين لتقديم واجب العزاء، تدفعني معرفتي بالرّيس جوزيف الذي برحيله فقدنا كنزًا ورمزًا اجتماعيًّا وأخلاقيًّا في منطقتنا، كما يدفعني تقديري لشخص زوج الراحلة ، فاكتشفت يومها ومن معالم حزنه، عمق إنسانيّة الإنسان في داخله، ورأيت على محيّاه كتلة متّقدة بالمشاعر والأحاسيس، وقرأت في وجهة ملامح معبّرة، وتأثّرت بالدّمع الذي انهمر متناهضًا مع أبّهة الصّخور وتلاطم الأمواج وحفيف الحزن في أوراق الشجر، وأكثر فأكثر ذلك الجمهور الحاشد حيث شاركه الحزن وبادله الإحترام.
ثمّ رحت أنحت كلماتي بإزميل الخير، وأرسل مشاعري على أجنحة الطّير، وأنا أشبه بفراشة تحوم فوق الأزاهير وتنجذب للعبير، أو أشبه بنحلة تنقل الرّحيق إلى القفير.
وفي الفدار يتعانق جمال الحجر والبشر مع عمق الإيمان فهناك عاشت أسطورة الجمال”‘ إيزيس”، وهنالك على ذلك الشّارف الصّخريّ يطلّ مار زخيا حاملاً الصّولجان والتّاج، ليومئ لأهل الخير من أجل تلبية كل معوذ أومحتاج. ويبلغ ذلك الإيمان أوجه في الإهتمام بسيّدة العناية حيث المجمّع الرّعويّ في وادي الجمال في ضيعة أدونيس، تحت تولية غبطة البطريرك الراعي، وبإدارة العائلة وفي سبيل الخدمة وعمل الخير.
ويبقى إيلي باسيل ذلك الوجه الخيّر واليد الممدودة، يسترق الأويقات بين شاطئ الفدار وتلالها، ليستريح على بساط الأيّام، ويسابق لحظات العمر من الفجر إلى العصر، في ملحمة هدوء ملائم وفي مسيرة إيمان دائم وفي جو تأملً هائم، و هو الذي بذر ويبذر أعماله خيرًا في حقول الزّمان، و يرسمها لوحة جماليّة على جدران المكان، و يعيش على تلك الأرض التي سقاها الله خيرًا وبركةً وازدهارًا، و نضمّ صوتنا إلى صوت ذلك المؤمن الذي يعيش الخدمة وفرح العطاء حين ناشد و صدح قائلا : ” كفى كفى لماذا دمّرتم لبنان..!!!” “أنا مسيحيّ ، ملكي يسوع ،دستوري الكتاب المقدّس ، لغتي المحبّة ، سلاحي الصّلاة ، مبدئي التّسامح و هدفي السّلام” .
أما كلمتي اليوم فهي بمثابة إيقونة جديدة أعلّقها على صدر أيامي، أو لوحة مزخرفة على جدار عمري، وإما أعتبرها وسامٌا جديدا بين ضلوع كتاباتي واسمٌا لائقٌا أزيّن به كلماتي، والكلمة غدا للتّاريخ. فلا بد أن تبقى نابضةً بالحياة، راويةً حكايةً من ترك بصماتٍ على جبين الوطن لا بل على جبين الإنسانيّة .